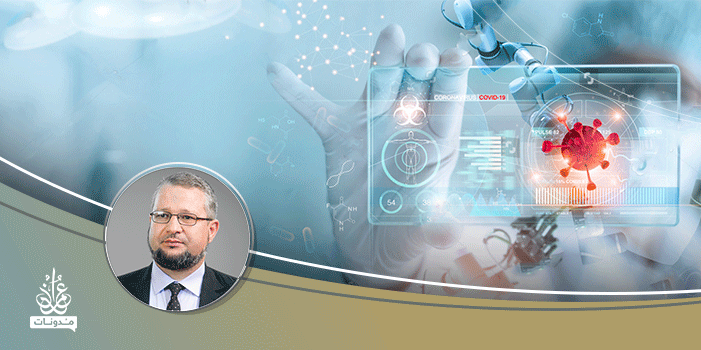ارتبطت بعضُ استعمالات التكنولوجيا الرّقمية في السّنوات الماضية بالقرصنة والجوسسة وانتهاك الخصوصية وتهديد الأمن القومي، إلاّ أنّ أزمة كورونا كشفت عن أصالة إيجابياتها ولمّعت من صورتها، وعزّزت من الأهمية الاستراتيجية لها، إذ أصبحت مؤشّرًا أساسيًّا في تصنيف الدول واستعراض مظاهر قوّتها، وأنها الأقوى في مواجهة الأزمات الكبرى للأمم، وأنها خطُّ الدفاع الأول عن الإنسان، وأنها أعادت رسم حدود العلاقة مع هذه التِّقنية، وسهّلت إنشاء عقدٍ تكنولوجي معنوي بالتنازل الطوعي على جزءٍ من الحرّية والخصوصية من أجل ضمان الحماية الصّحية، يحاكي ذلك العقد الاجتماعي لجان جاك روسو في حدود العلاقة بين السّلطة والمواطن من أجل ضمان الحقوق والحرّية.
وبالرّغم من حجم الصّدمة من فاجعة كورونا، والتي أصابت البعض بالذُّهول والاستسلام، ورسمت صورةً سوداوية قاتمة، وكشفت عن حجم ذلك التواضع في مواجهة هذا الفيروس الصغير، إلاّ أنّ الصّين أثبتت علميًّا وعمليًّا قوة الاعتقاد في الشّفاء الذي ورد في الحديث النبوي الشّريف: "ما أنزل الله داءً إلاّ أنزل معه دواء، علِمه من علمه وجهِله من جهله."، مجسِّدة قِبلة العلم التي يُحجّ إليها كما ورد في الحديث بالمتن المشهور: "اطلبوا العلم ولو في الصّين.."، وقد فتحت نافذة واسعة للأمل في الحدّ منه، فقد وضعت العلم والتكنولوجيا في قلب استراتيجية المواجهة مع كورونا، بعد أن ظهر متحدّيًّا القدرات العلمية والعقلية للإنسان، وأعلن في البداية أنه وباءٌ معقّدٌ ومستعصٍ عن الحل، وخاصة في مراحل الذروة والخروج عن حدود السيطرة، إلاّ أنّ محنته قد تقفز بالبشرية خطواتٍ متقدّمة في مواجهة التكنولوجيا للبيولوجيا، وتحديدًا في مواجهة مثل هذه الأوبئة المفاجئة والغامضة، لتعلن أنّ سلطان العلم هو وحده مَن يمكّن الإنسان من السّيادة في هذا الكون، مصداقًا لقوله تعالى: "يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ" (الرّحمن:33).
قد أبهرت الصّينُ العالم بأسره، وهي بؤرة كورونا الأولى، وقد أصبحت الناجي الأول من هذا الطوفان في وقتٍ قياسي، وأثبتت أحقّيتها في الزّعامة في هذه المرحلة على الأقل، خاصّة مع هذا التطوّر التقَني والتكنولوجي المذهل في مواجهة هذا التحدّي المرعب.
إذ تحوّلت إلى أكبر منصةٍ تكنولوجيةٍ متكاملةٍ للدفاع عن البشرية أمام جبروت كورونا، ودفعت بمعركة التقنية إلى الواجهة وإلى المواجهة.
وما على الدول الغارقة في وَحْل هذه المصيبة إلاّ أن تتعلّم من التجربة الصينية في معركتها الشّرسة ضدّ هذا العدو الجديد، بالطرق التكنولوجية الدقيقة السّريعة وغير التلامسية، منها:
الرّوبوتات الذّكية متعدّدة الخدمات
والتي لم تستغرق طويلاً في جاهزية الخوارزمية والانتقال من المحاكاة إلى الممارسة، وقد تمّ الاستثمار فيها بفاعليةٍ كبيرة، والدفع بها إلى الخطوط الأمامية لهذه المواجهة، إذ تختلف عن الإنسان فلا تُصاب بالعدوى، وهو ما يدفع بها لاقتحام المهام الاستثنائية في الأماكن الخطرة، في خدماتٍ ذاتِ أبعادٍ صحيةٍ واجتماعية كمنصاتِ تشخيصٍ ووقايةٍ وخدمة، مما ساعدها على الاندماج السّلس في حياة الإنسان.
وهي روبوتات متنوّعة ومعزّزة بتقنياتٍ عاليةِ الذّكاء والدّقة، فمن الرّوبوت الممرّض الذي يفحص 10 أشخاص في وقت واحد، إلى الرّوبوت الجوّالة الذي يفحص في الشوارع ويعطي النصائح الصوتية، إلى الرّوبوت الذي يوصل الطلبات ويقوم بالتعقيم، إلى السيارات الخَدَمية ذاتية القيادة، إلى المستشفى الميداني الذّكي، الذي يتمّ تنفيذ خدماته الطبيّة عبر الروبوت وأجهزة إنترنت الأشياء، إذ يمكنه تقديم الخدمة لحوالي 20 ألف مريض، مثل توصيل الطعام والدواء، وتقديم المعلومات الأساسية عن الفيروس وكيفيات التعامل معه، وفحص المرضى بواسطة موازين الحرارة المتصلة بتقنية الجيل الخامس، وارتداء المرضى للأساور الذكية التي تحتوي على أجهزة استشعارٍ متزامنة مع منصّة الذكاء الاصطناعي للتعرّف السّريع على الحالات.
الطائرات المسيّرة (الدرونز)
ففي الوقت الذي تُستخدم فيه هذه الطائرات في الحروب والمأساة الإنسانية في اليمن وسوريا وغيرها، فهي لدى الصينيين إحدى أهم التكنولوجيات الفعّالة في مواجهة وباء كورونا، حيث نشرت الصّين آلاف الطائرات المسيّرة في كل أنحاء البلاد للمساعدة في إجراءات مكافحة الفيروس، وقد استُخدمت في عدّة مجالات، منها: تنفيذ دوريات المراقبة عبر كاميرات يمكنها تقريب الصورة 40 ضعفًا، تمكّن من كشف الأشخاص المخالفين للإجراءات الوقائية، وضبط حركة المرور، ونقل المستلزمات الطبية وعيّنات الكشف الصّحي، ونشر التعليمات اليومية بواسطة مكبّرات صوت، وتعقيم الأماكن العامة عبر رشّ المطهّرات بانتظام، وكذلك إمكانية الكشف عن الأشخاص المصابين بتقنية التصوير الحراري عبر الأشعّة تحت الحمراء.
الذكاء الصناعي
فقد اعتمدت الصّين على الحجم الهائل للبيانات والمعلومات من خلال خوارزميةٍ ذكية تجمع بين السّجل الصّحي والملف الجنائي وخارطة السّفر عبر وسائل النقل العامة للكشف عن المصابين والإسراع بالحجر الصّحي عليهم.
كما تمّ استخدام تقنيات ذكية في تحليل بِنية الفيروس وكيفيات انتشاره، مثل خوارزمية الطّي الخطّي، وهي أسرع من الخوارزميات السابقة بـ: 120 مرة، وتطوير طرق الاستشعار الحراري بالأشعة تحت الحمراء للكشف عن المصابين في الأماكن العامة، إذ تستطيع الكشف عن 200 شخص خلال دقيقة، كما استخدمت الشرطة ورجال الإطفاء خَوْذاتٍ ذكية وكاميراتٍ حرارية للكشف عن بُعد، بدقّةٍ عاليةٍ وبنِسبِ تعرّفٍ تصل إلى 96%.
الهواتف والتطبيقات الذكية
إذ أنّ الإجراءات الحكومية لوحدها لم تكن كافيةً لمواجهة هذا الوباء الدّاهم، وهو ما تطلّب جهودًا تشاركية وتعاونية مع المواطنين، فقد أطلقت الحكومة الصينية تطبيقاتٍ لهواتف ذكية تسمى (كاشف الاتصال الوثيق)، لها القدرة على تعقّب الفيروس والتنبؤ بالمصابين القريبين ومسح الأشخاص المحيطين، وذلك باستعمال الكود الصّحي، واعتماد نظامِ تصنيفٍ صحّي مُرمّز بالألوان: الأخضر والأصفر والأحمر، يمكنه الكشف عن ملايين الأشخاص يوميًّا، إذ بمجرد إدخال الاسم والرّقم الوطني للشخص يتمّ الكشف عن خارطة الأشخاص المشكوك في إصابتهم، وبالتالي الإسراع في الاحتراز منهم وعزلهم والتكفّل بهم.
كورونا تفرض الصّداقة بين الإنسان والتّقنية
فقد فرضت إجراءات الحجر الصّحي وإجبارية عدم الاتصال المباشر بين البشر وما يترتب عنها من التأثير السّلبي على اللقاءات والعلاقات والنشاطات باللجوء إلى التكنولوجيا الرّقمية لإنقاذ ذلك، وستتطوّر الحاجة الالكترونية في العمل والدراسة والاجتماعات والأعمال والتحويلات والتجارة والترفيه والرّياضة وغيرها عن بُعد، وهو ما سيعزّز العالم الافتراضي في حياة الإنسان، والانتقال من الإدمان إلى الأمان مع التكنولوجيا الرّقمية، وأنّ الذين سيتخلّفون من الأفراد والأحزاب والمنظمات والمؤسّسات والدول عن إدراك أهمية هذه التّقنية سيتجاوزهم الزّمن، وأنه لا مكان لهم تحت الشّمس بدونها فيما بعد كورونا.
إنّ التطوّر التكنولوجي الرّقمي ليس مجرد قرار، بل هو مسارٌ استراتيجيٌّ طويل، لا بدّ أن تُعطى له الأولوية القصوى، وبه إمّا أن نكون أو لا نكون.