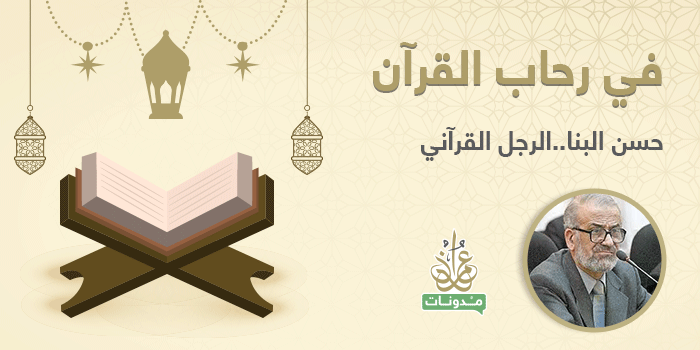استعرضت في المقال السابق (القرآن الكريم في مواجهة العالم المعاصر) أفكار جميع المصلحين بشكل موجز جداً، لأن الحديث عن جميعهم يحتاج إلى عدة محاضرات، ولكنّي قلت بأن هؤلاء المصلحين ظهروا في العصر الحديث عندما تغيرت الظروف، وجابه المسلمون حضارة شاملة ذات فلسفات متعددة، وذات أفكار متبانية أو متفقة، وذات إنجازات كبيرة جداً ومغرية جداً.
غير أن التركيز صُبَّ على بلدين إسلاميين، وهما: تركيا التي قضوا على الخلافة فيها من خلال الاتحاد والترقي الماسوني، وإعلان العلمانية المتطرفة التي أرادت أن تقطع جذور تركيا من الإسلام. والبلد الثاني مصر، لأن مصر فيها الأزهر، وفيها مثقفون، وفيها الصحافة وفيها المؤسسات الثقافية، وفيها جيش بقيادة العرابي الذي أراد طرد الإنجليز من مصر ولكنه لم ينجح. فثورة عرابي جعلت الهجمة على مصر شاملة في كل نواحي الحياة، بوجود الاستعمار في قناة السويس، على بعد 100 كم عن القاهرة بـ 80000 جندي بكل عتادهم، ومع اعتداء جنودها في كل يوم أحد كانوا ينزلون فيه إلى القاهرة على الناس وتحرشهم بالنساء. وبانتشار الماسونية في كل أبواب مصر. بحيث في أواخر القرن التاسع عشر لم يكن أحد يتقدم أو يدخل الوزارة أو يتسلم وظيفة كبيرة إلا إذا كان ماسونياً. والدليل، أن الأفغاني لما جاء إلى مصر قالوا له بأنك لن تستطيع أن تتحرك وتؤثر وترتاد الأندية إلا إذا دخلت في الماسونية!
ويومئذ الماسونية لم تكن معروفة، وحقائقها كانت مخفية في ذلك الوقت، وإنما كانوا يقدمون أنفسهم بأنهم جماعة حرة تريد مصلحة الإنسانية. وسيطرت هذه الماسونية على كل شيء حتى بعد مجيء القرن العشرين، فسيطروا على التربية والتعليم عن طريق (دنلوب) الذي كان قسيساً، وجاء به الإنجليز مختصاً في التربية والتعليم، و بقي عشرين عاماً (1899-1919) يوجه الثقافة والتربية والتعليم في مصر، في ظل حراب الإنجليز وفي ظل علمانية متطرفة جداً. ومجال الفن، الذي أثر في العالم العربي من يومئذ كان تقوده الماسونية. حتى إنني سنة 1965 في أول عهدي بالقاهرة عندما ذهبت لدارسة الماجستير، كنت أتجول وإذ بي أمام قطعة كبيرة مكتوب عليها الجمعية الماسونية الفنية المصرية.
إذن، مصر ركزوا عليها لأنهم خافوا أن تنتقل الخلافة إليها، كون المصريين كانوا متألمين جداً لإلغاء الخلافة، ولأن الشعب المصري كان من الممكن أن يكون زعيماً للعالم الإسلامي بوجود الأزهر والعلماء والمفكرين الإسلامي.
وإصلاح الوضع في مصر لم يكن من نصيب عالم أزهري أو مفكر ديني، بل كان يحتاج إلى ظهور شاب يملأ القرآن كل كيانه. هذا الشاب الذي حمل القرآن بيده، وواجه هذا الوضع في مصر يومئذ، لأنه أدرك أن هذا القرآن هو الذي يستطيع أن يدرأ هذه الفتنة. هذه الفتنة الكبرى كانت تحتاج إلى الصراحة، وإلى تقديم الإسلام شاملاً كاملاً صريحاً بحمل القرآن الكريم، وليس بالعلوم الإسلامية التي كانت تدرس في الأزهر وغير الأزهر، وكثير من هذه العلوم دخلت في عالم الجمود والخمود.
فلم يكن لها إلا شاب نشأ نشأة في بيت كريم بالإيمان والإسلام، تحت ظل شيخ روحاني رباه من الصغر وحفظه القرآن، متفوقاً في دراسته، وكان والده أيضاً عالماً ومحدثاً وقد درس عليه وعلى غيره من العلماء العلوم الإسلامية.
كان المجتمع لا يحتاج إلى فقيه، وكان البنا فقيهاً، والدليل على ذلك حدث معي، عندما دعيت سنة 1984 إلى إلقاء المحاضرات في جامعة محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، ورأيت هناك أستاذاً للاقتصاد جاء أيضاً للتدريس، وكنت أذهب يومياً معه بنفس السيارة من السكن إلى الجامعة، فتعرفت عليه، وكان اسمه اسماعيل شحاتة. قال لما أردت أن أسجل رسالتي في جامعة القاهرة بعنوان (النقد في الاقتصاد الإسلامي)، ولما قدمت إلى لجنة الأساتذة الذين كانوا يديرون امتحان الطلاب، ضحكوا علي بالإجماع، وقالوا: يا إسماعيل، الإسلام هو الصلاة والصوم والذهاب إلى المساجد. ما لك ولنقد الاقتصاد الإسلامي، ومن أين جئت بهذا الكلام؟ فرفضوا. وأنا ألححت عليهم، وفي كل مرة يرفضون، حتى قال أحد الأساتذة: يا جماعة، هذا طالب يريد أن ينتحر، فدعوه ينتحر. فوافقوا على كتابة الرسالة. وقال: فذهبت إلى البيت في الليل ألطم على رأسي، لا أعرف المصادر، وإنما الحماسة دفعتني لذلك. ولا أعرف شيئاً في هذا الموضوع، ولا قرأت شيئاً، وإنما ثقافة إسلامية عامة دفعتني لذلك.
فذهبت يوم الثلاثاء إلى درس الإمام البنا. فلما انتهى الأستاذ من المحاضرة دخلت إلى غرفته مع الناس، وسلموا عليه وأنا بقيت أنتظر حتى خرجوا جميعاً، فنظر إلي الأستاذ البنا مبتسماً وقال: ماذا عندك يا شحاتة؟ قلت: والله يا أستاذ وقعت في داهية كبيرة، فقصصت عليه ما حدث معي، فقال: أهذا كل ما في الأمر؟ يسيرة إن شاء الله. فأجلسني أمامه وأعطاني ورقة وقلم، وأملى علي 37 مصدراً في جميع المذاهب الإسلامية، وأين ذكر هذا الموضوع! أليس هذا يدل على أنه كان فقيهاً وراسخاً في الفقه؟ لكن المجتمع لم يكن يومها يحتاج إلى إظهار فقيه جديد، فقد كان الأزهر مملوءاً بالفقهاء. كان المجتمع والعالم الإسلامي يحتاج إلى الانبعاث من القرآن مرة أخرى.
ما هي أساسيات فكر الأستاذ البنا المبتعث من القرآن الكريم؟
أولاً، كان عندما يتكلم في تفسير القرآن الكريم ينطلق في ضوء أصول و قواعد ومقاصد القرآن الكريم لصياغة المذهبية الإسلامية بتفاصيلها الشاملة في الخالق والمخلوق والكون والمجتمع والإنسان. لم يكن موضوعاً واحداً، وإنما جاء الموضوع كما الحضارة الغربية شاملة في مسائل الكون والحياة والمجتمع والإنسان، ولكن من منطلق مادي بقيادة الفلسفات المادية الخمس (الوضعية، الوضعية المنطقية، والماركسية، الوجودية، والنفعية).
هذه الفلسفات المادية قادت الغرب قيادة شمولية في كل مسائل الحياة، وكانت النتيجة قضايا مادية رائعة، إنجازات عظيمة، ولكن في انطلاق من مادية كاملة، وعلمانية شديدة ضد التأريخ المسيحي المتصادم مع الحرية ومع العلم عبر التأريخ. وكان هذا رد فعل، لأن كثيراً من العلماء أحرقوا بقرار من الكنيسة. فكانت المسألة تحتاج إلى منهج شامل للمواجهة الحضارية، وقد قدمه الأستاذ البنا بتفاصيله في فكره الإسلامي المتجدد.
ومن أوائل ما فعل، كتابته للأصول العشرين حتى لا يختلف الناس في مواجهة العالم الغربي. لأن قبل ذلك، كان المجتمع الإسلامي في مصر فيه تمزق ديني أيضاً، الصوفية ضد السلفية، والسلفية أجنحة، والصوفية أجنحة، والفقهاء ضد هؤلاء وهؤلاء، ودار العلوم منهجها يختلف عن الأزهر، فكان يحتاج إلى أن يصوغ عشرين نقطة (أصل)، وهذه الأصول العشرين انطلقت من قواعد وأصول ومقاصد القرآن الكريم، وما بني عليها من علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة وقواعد الفقه الإسلامي.
وأول مبدأ في هذه النقاط العشرين إعلان أن الإسلام نظام شامل للحياة. هذه الشمولية بهذه الصراحة، بهذا الفكر المنور الواسع لم تكن موجودة بشموليتها في العالم الإسلامي، فكل مجدد كان مشغولاً بقضية حلول المشكلات التي كانت موجودة في بلده. فالإمام البنا في أول نقطة يقول: ((الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعاً)) العلمانية أفهمت الناس أن الإسلام دين في المساجد، حركة الحياة والحضارة لا علاقة لها بالإسلام. ((فهو دولة و وطن أو حكومة و رأي)) لماذا؟ لأن الدولة تحتاج إلى حكومة، ووطن يحتاج إلى وجود أمة ((وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة)) الخلق رئيسه الرحمة.
ولذلك رب العالمين في رأس كل سورة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإذن، الرحمة أساس الخلق، وتقود جميع الأجنحة الأخلاقية الأخرى. والقوة بدون عدالة لا تساوي شيئاً. ولذلك لما اتفق المنتصرون في الحرب العالمية الثانية وسطروا حقوق الإنسان، لا ترى فيها نقطة واحدة تتحدث عن العدالة وإنما عن السلام. وعندما تقوم حرب بين الغرب ودول أخرى سرعان ما يلجأون إلى السلام حتى يسيطروا هم، فلا توجد عدالة. ((وهو ثقافة و قانون)) الثقافة إذا لم تنتهي إلى العلم تكون عامة لا يمكن أن تحصر، وكذلك القانون ، ولذلك قال ((أو علم و قضاء)) الثقافة يجب أن تنتهي إلى العلم، والقانون لا بد أن يطبقه القضاء. (( وهو مادة و ثروة أو كسب وغنى )) لأن المادة يجب أن تعود إلى الكسب حتى تتحرر والغنى نتيجة الثروة ((وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة)) الجهاد ماذا يفعل إن لم يكن هناك جيش قوي في الدولة؟ وأيضاً الدعوة تحتاج إلى فكرة ((كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء)).
هذا العرض والصياغة في هذا الشكل و هذه الصراحة وهذا السطوع لم يكن موجوداً من قبل.
ولكن أحدثكم حديثاً عن الرجل العالم الوزير الدكتور عبدالله النقشبندي ابن مصطفى النقشبندي من أكابر علماء ومرشدي الكرد. جاء إلى القاهرة، ويقول: تعرفت على حسن البنا وكنت أتردد على الجمعيات الإسلامية، فكنت من ضمن من أدخل عليهم واحد من كبار علماء مصر -الذي انتخب فيما بعد شيخاً للأزهر- وهو محمد الخضر الحسين، وهذا عالم من الصادقين الربانيين. قال –وكان في تأريخ حسن البنا أنه كان كثيراً ما يتردد على هذا الشيخ– فلما جلست دخل حسن البنا وسلم علينا وقال للأستاذ: يا أستاذ أقرأت النقاط العشرين؟ على أساس أنه يقرأها بغرض إبداء الرأي فيها والتصحيح، أو لتنبيهه ما إذا كانت هذه النقاط ستسبب خلافات بين المسلمين -والبنا حريص بأن يوحد الجميع لمقابلة الاستعمار الإنجليزي وأعداء الإسلام في مصر- فقام الشيخ خضر الحسين وأخرج الصفحات التي كتبت عليها الأصول العشرين وقال: بارك الله فيك، والله إنني لم أجد فيها فرقة هذه النقاط، كلها موحِّدة وهذه كلها مختارة من كتب الأصول والمقاصد لم أستطع أن أزيد لك فيها شيئاً.
ومن فكر الأستاذ البنا إيمانه بالشورى والعدالة. وكل ما فعل أراد به أن ينقذ الشعب المصري المستضعف من يد المستعمر الإنجليزي الطاغي والباشاوات والإقطاعيين. ثم أن فكر البنا لم يكن فكراً ثورياً موجهاً إلى إسقاط الدولة، بل كانت علاقاته بجميع رؤساء الأحزاب وبجميع ممثلي الدولة علاقات فيها كثير من المودة والنصح، لماذا؟ لأنه كان يؤمن بضرورة تربية المجتمع الإسلامي أولاً، بدأً من الفرد إلى البيت المسلم إلى المجتمع المسلم، وكان يقول إذا أردتم أن تصلوا إلى دولة تطبق شريعة الإسلام فلا بد أن يكون المجتمع مسلماً مهيأً حتى هو يقوم بهذا الدور، لا حزب واحد ولا شخص واحد ولا جماعة واحدة. وكان يؤمن بالبناء وليس الهدم، ما معنى البناء؟ يعني أنه لم يثر قضايا الفرقة بين المسلمين حتى يضرب بعضهم ببعض، ولم يكن بمواجهة الدولة أو أي حزب مواجهة فاجرة، وإنما كان يدعوهم إلى التمسك بعظمة الإسلام، وبتطبيق شريعة الإسلام لأنها هي التي فيها الحل وليس في غيرها. وكان يدعوهم ويقدم لهم المذكرات بكل احترام. فإذن، كان بنّاءً في فكره وليس هداماً. وهكذا بيّن فكره في رسائله وخطاباته ومحاضراته التي الآن جمعت في عدة مجلدات. وكان يعتقد أن مواجهة الحضارة الشاملة يحتاج إلى مخطط إسلامي شامل كما كان في أول الإسلام، ولذلك انتبه إلى فكره ودعوته قادة المنظمات الغربية العلنية والسرية، وحاربوه بكل ما أوتوا من قوة، ونفذ الملك فاروق اغتياله.
وهنا أود أن أعود وأطرح الخصائص الفكرية لكل المجددين والمصلحين الذين تكلمت عنهم:
- أولاً، كلهم متفقون على أن العقائد الإسلامية لا بد أن تعتمد على الكتاب والسنة، لأن الصراعات التي حصلت بين المذاهب العقدية سببت فرقة كبيرة. و لذلك قالوا: تيارات الفكر الإسلامي القديمة تيارات اجتهادية، أصاب من أصاب وأخطأ من أخطأ وكلهم كانوا ينطلقون من مصلحة الإسلام.
- ثانياً، وجوب تقديم مذهبية الإسلام في الكون والحياة والخالق والإنسان بمقابلة المذهبيات الغربية. لا يكفي أن نقدم كتاباً في علم الكلام أو العقائد، إذ كلها كانت مناقشات فلسفية غير مفهومة للمسلمين، ولاتخدم مواجهة الأفكار والفلسفات المعاصرة.
- ثالثاً، فهم السنن الإلهية. القرآن الكريم فيه سنن إلهية، لأنني كما قلت لكم بأن القرآن الكريم قدم تجليات الأسماء الحسنى، بناه الله تعالى بإرادته ومشيئته على تجليات الأسماء الحسنى في الكون. والتفاسير القديمة مع الأسف لا تتحدث عن هذه السنن الإلهية. والحقيقة أن هذه السنن استنبطناها نحن في العصر الحديث من أسس الحضارة الغربية التي هاجمتنا، فهم نظروا في السنن وبنوها على أسس مادية. بينما السنن الكونية مبنية على الأسماء الحسنى وأنوار تجلياتها في القرآن الكريم.
- رابعاً، محاربة البدع والمنكرات. فعبر التاريخ دخلت بدع ومنكرات حسبت على الإسلام وكُفّر الناس عليها وضُللوا.
- خامساً، دراسة الشريعة دراسة كلية وبيان النظريات الشرعية الكلية. وعدم وجودها هو الذي أتى بالنظريات الغربية في قوانيننا، في حين أن الفقهاء في العصور الأخيرة شغلوا أنفسهم بجزئيات الفقه، ولم يتكلموا عن النظريات، مثل النظرية السببية، ونظرية التعسف في استعمال الحق، وإلى ذلك من النظريات التي ظن الناس أنها جاءتنا من الغرب.
- سادساً، حل المشكلات الإنسانية المعاصرة في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التي تشمل حياة النبي (صلى الله عليه وسلم).
- سابعاً، موقف موحد من الاستعمار، والدعوة لإنقاذ العالم الإسلامي من براثن الاستعمار.
- ثامناً، تحويل هذه النظريات عملياً إلى بناء المجتمعات والجماعات. إذ لم يكتفوا بتأليف الكتب وتقديم النظريات، وإنما دعوا إلى التكاتف وبنوا الجماعات الإسلامية، وتنظيمات المجتمع المدني.