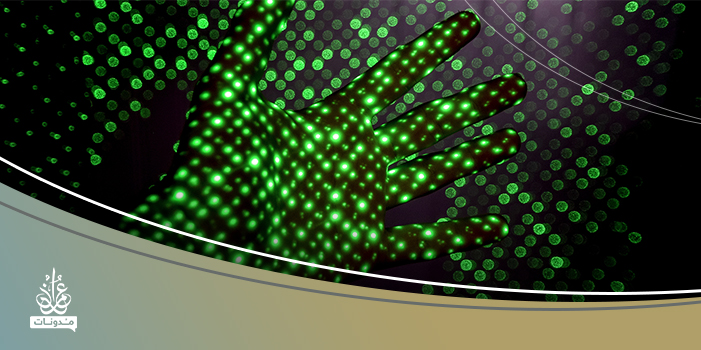أوّل ما تسمعه عند المقارنة بين التعليم في الماضي والحاضر أنّ معلّم الأمس كان شديدا متفانيا صارما مع التلاميذ يُشبِعهم ضربا ولا يُلام في ذلك، أمّا معلّم اليوم فهو ليّن متهاون في التّعامل مع التّلاميذ غير مُحتَرم ولا مُهابٍ كما كان سلفه. فما هي الأسباب الّتي أدّت إلى تغيّر هذا المعلّم؟ وهل صحيح أنّ معلّم الأمس أفضل من معلّم اليوم؟
المعلّم هذا الّذي نتكلّم عنه اليوم هو ابن بيئته وفرد من أفراد هذا المجتمع، كان فيما مضى له مكانة مؤثّرة في محيطه رغم النقائص الّتي كانت تشوبه كمُرَبٍ، كان يُعامل التّلاميذ كأبنائه، أي نعم كان قاسيا وشديدا عليهم، لكنّه خرّج جيلا مُثَقّفا واعيا بنسبٍ مُعيّنةٍ ومتفاوتَةٍ وفي نفس الوقت جيلا عصبيّا لا يقبل النّقاش ولا يتحلّى بآداب الحوار، وهذا ليس مسَبَّة لمعلّم الأمس فهو أيضا بدوره وريثٌ لِما وَرَّث، وأُشرب هذه المعاملة الخشنة الفظّة من الجيل الّذي سبقه، وهذا راجع لأسباب عدّة تراكمت بمرور الأجيال.
التعليم في الماضي كان تعليما محلّيا لا دخل للفيسبوك والأنترنت فيه، تعليما وطنيا خالصا قاعدته المرجعية هي التعليم الكُتّابيّ، فتعليم القرآن في الكتاتيب نشاط متوارث عبر قرون، ونحن المسلمون نمتلك عاطفة جيّاشة عمياء اتجاه الدّين وعلومه لدرجة أنّنا لا نراعي الفروقات الفرديةً في درجة الاستيعاب لدى الأطفال، فمن يحفظ بسرعة يُجازى ومن يتخلّف يُعَنّف لفظيا وجسديا بحجّة أنّه متهاون. وهذه الطريقة نجحت في تخريج حُفّاظ ونوابغ برزوا وطوّروا وجدّدوا وأبدعوا، وبالنّظر إلى خواتيمها فهذه الطريقة ناجحة تماما فلولاها لما حُفِظ القرآن وعلوم الدّين ولما وصلت إلينا عبر عصور لم تعرف غير المحبرة وجلود الأنعام أو الورق الأصفر الخشن.
أمّا التّعليم الحالي فليس محلّيّا وتغيّر شكلا ومضمونا ولا يُراعي ظروفنا المحلّيّة، بل وتكلّم العديد من الخبراء أنّ أساليبه وطرائقة ومناهجه الحاليّة وضعها أصحابها وهم يُبيّتون النّيّة لهدم ما كان يمتاز به أسلافنا عن غيرهم من الحفظ والتّدوين والنّقل، حيث استورد أصحاب القرار مناهج بأكملها من دول غربية دون تكييفٍ ولا تكوينٍ للمعنيين بتنفيذها، لذلك أضحت الأنترنت ملاذ معظم المعلّمين يستقون منها ما يشاؤون ويفهمونها كيفما يشاؤون، فوقع هذا الخلط في المفاهيم والأساليب، وانعكس سلبا على تحصيل التّلاميذ.
ضف إلى ذلك الحملات التي تقودها الصّحافة تحت رعاية صُنّاع القرار لتشويه صورة المعلّمين بترصّد زلاتهم واتّهامهم بالسّعي وراء المال فقط، هذا المعلّم أليس فردا في المجتمع له احتياجات ومطالب مادّيّة كباقي أفراد المجتمع؟
بل هو من أوائل من يجب أن تُلبّى حاجاته الاجتماعية ليتفرّغ لعمله الإنساني الرساليّ، فكيف للمعلّم أن يخصّص وقته وفكره وجهده لتبليغ رسالته وهو قد سُرِقت منه آدميّته ببحثه اليوميّ عن مركبة يتنقّل بها أو عن مأوى يكِنُّ فيه ليلا؟ هذا لا يعني أنّ معلّم الأمس كان يعيش في سعة مالية، لا. ولكنّ المكانة المعنوية المرموقة التي كان يحتلّها في المجتمع آنذاك كانت تواسيه في عوزه المالي.
أيضا كان معظم النّاس فيما مضى متساوون كأسنان المشط لا يمتاز أحدهم على الآخر إلّا بالعلم والتربية والحكمة، أمّا اليوم فتغيّرت المعايير أو بالأحرى غُيِّرت فصار الامتياز بالمال والمسكن والمركب، فانتقلت المكانة المرموقة من عند صاحب العلم إلى الانتهازيين من المقاولين ورجال المال الفاسد ونجوم الغناء والتمثيل، وتحوّلت معها آمال وطموحات المتعلّمين من جمع العلم إلى جمع المال.
المعلّم إنسان يتأثّر بما حوله من ظروف ومتغيّرات، فكما تغيّرت الظروف والبيئة المحيطة به تغيّر هو أيضا وصار في أحيان كثيرة غير مُبالٍ بتبليغ الرسالة الموكلة إليه، فانهالت عليه الشتائم والتّهم ولم يخطر ببال مُنتقِديه أنَّ المعلّم تغيّر ربما للسّيّئ كما تغيّر كلّ المجتمع للأسوأ، وحتّى معلّم الأمس ربما كان سيتغيّر إلى نفس المصير لو عاش في ظروف وبيئة اليوم، فالمقارنة هنا جائرة لأنها جرت بين أفراد فئة واحدة من حقبتين مختلفتين فلا الظروف متشابهة، ولا العقليات بقيت كما كانت، ولا الاهتمامات ثبتت على ما كانت.