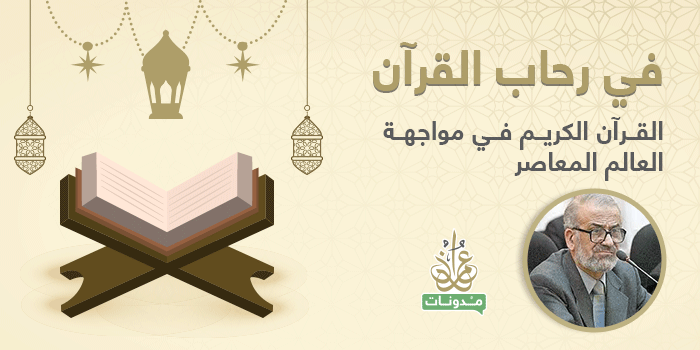من الضروري أن أرجع سريعاً إلى الماضي عند الدخول في العصر الحاضر والتحدث عن التحديات التي جابهت الأمة الإسلامية وقوة وضعفاً إلى أن أدخلتنا إلى ما نحن فيه من الوضع المتأخر.
كل حضارة تقوم في هذه الدنيا وكل دين قام في هذه الدنيا لا بد أن تواجه أو يواجه مع مبدئه التحديات. وتتسلسل هذه التحديات مع تسلسل مرور الحضارة قوة وضعفاً في تباطح مستمر إلى أن يسقط الواحد الآخر.
ففي صدر الإسلام، أول ما واجه النبي (صلى الله عليه و سلم) تحدي المشركين في مكة، و تحدي المنافقين واليهود في المدينة. وأما الخلفاء الراشدون فقد واجهوا تحدي الردة أولاً، ثم تحدي مواجهة باقي الأمم. وقد كان عهدهم قوياً، ولكن تلك التحديات في النهاية استطاعت أن تقضي على الخلافة الراشدة في غضون ثلاثين سنة.
ثم تحول الحكم إلى الأمويين، وتحدياتهم كانت كبيرة، استطاعوا أن يقضوا عليها بالحسنى أو بالدماء، لكن بعد ذلك استطاعت هذه التحديات أن تقضي عليهم وأن تأتي بالعباسيين. وقام العباسيون في دولة قوية و لكن التحدي كان مستمراً. واستطاعوا الصمود في بداية عهد قوتهم في وجه التحديات الداخلية والخارجية. ثم استمرت التحديات في وجه العباسيين وبدأ الضعف شيئاً فشيئاً يتمكن منهم، فيسيطر البويهيون مرة، والسلاجقة مرة، وهكذا شيئاً فشيئاً وبدأت تضعف أمام هجمات الصليبين وأخيراً دخل هولاكو وسقطت بغداد.
ثم ظهرت الدولة العثمانية التي كانت تمثل احتياج المسلمين للقوة لحفظ كيانهم، والدولة العثمانية لم تلجأ إلى المشرق حتى تعالج المشكلات القائمة، وإنما كانت دولة عسكرية قوية تتقدم إلى الغرب إلى أن استطاع محمد الفاتح أن يفتح القسطنطينية.
ثم ضعفت الدولة العثمانية مع مرور الأيام وبدأت تضعف أمام التحديات، حتى جاءت الهجمات الأجنبية والتآمر الماسوني الذي لم يكونوا على علم به في بداية الأمر، فسقطت الدولة العثمانية ودخلنا في تحديات العصر الجديد.

أوضاع العالم الإسلامي بعد سقوط الدولة العثمانية (وحتى قبل سقوطها بعقود من الزمن)
- أولاً، الاستبداد السياسي: والذي استمر تماماً بقوته وسيطرته وباغتصاب حقوق المستضعفين المقهورة تحت سلطان الحكام في جميع أنحاء العالم الإسلامي.
- ثانياً، الظلم الاجتماعي: أي عدم وجود العدالة التي دعا إليها الإسلام بين طبقات المجتمع، فعلت طبقة على طبقة، طبقة مترفة، وطبقة –وهي تمثل الأغلبية- مستضعفة فقيرة ما تستطيع أن تفعل شيئا.
- ثالثاً، البعد عن هداية القرآن: روح القرآن الكريم فُقِدَت عبر القرون الأخيرة نتيجة لدخول العلوم الإسلامية إلى التفاسير القرآنية، والعلوم العقلية واللغوية وحتى بعض المخرقات الصوفية في بعض التفاسير التي أبعدت آية عن آية، فحُرِم المسلمون هداية القرآن الكريم، ولم يُقَدّم إليهم كما قدمه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى أصحابه. إذ أن المفسرين للأسف –على جلالة قدر المفسرين وعظيم نيتهم- لم ينتبهوا إلى هذا النقص.
- رابعاً، إهمال السنة النبوية: هذا الإهمال كان ممزوجاً بين الحديث النبوي والسيرة النبوية، فانشغال العلماء في حجرات المساجد في العالم الإسلامي بدراسة الكتب اللغوية والعقائدية والفلسفية ومنطق أرسطو - التي فقدت الصلة بالعصر الحديث - سبباً في ذلك.
- خامساً، التعصب المذهبي: وهذه المذاهب العظيمة التي توصّل إليها أئمتها من أجل مصلحة المسلمين، إذ كانوا يجتهدون ويقولون يكفينا ما يأتينا من الكتاب والسنة نأخذ به، إن لم نجد في الكتاب نجد في السنة، وإن لم نجد في السنة نجد في إجماع الصحابة، وإن اقتصر الأمر على فلان وفلان فهم رجال ونحن رجال.
ولكن الذين جاؤوا من بعدهم دخلوا في مرحلة التعصب، وهذه المذهبية استمرت إلى نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن المنصرم. حتى أنني أتذكر في بداية شبابي علمت أن مسجداً فيه منبران، فذهبت للمسجد يوم الجمعة، وإذ بي أرى خطيبين على منبرين، أحدهما شافعي والآخر حنفي، وكلاهما يتكلم في نفس الوقت والناس لا يدرون من يسمعون، ولكن الحمد لله انتهى ذلك بعد مدة قصيرة من الزمن. ولذلك كانت العصبية المذهبية تحدياً كبيراً أخرت تقدم وتطور الحضارة الإسلامية.
- سادساً، فقدان الأمة وحدتها السياسية: وآخر كيان كبير يجمع الأمة -على ما كان فيه في القرن الأخير من ضعف- سقط بعد الحرب العالمية الأولى، وهو الدولة العثمانية، فتمزقت الأمة ووزعتها دول الحلفاء المنتصرة بينها.
- سابعاً، انتشار البدع والخرافات: والبدع والخرافات إذا انتشرت في أمة تقضي على أصالتها، وتقضي على دينها الحق، وتقضي على حقائقها التي صعّدتها إلى القمة، فأنزلتها بعد ذلك هذه البدع والخرافات البعيدة عن الدين، والتي دخلت في عقول الجماهير الإسلامية عبر تكيات وخانقات، وأبعدت المسلمين عن حقائق الدين، وكانت نتائجها فيما بعد وخيمة جداً.
هذا التأخر العام من جهة، حاذاه الجمود والخمود الذي دخل المدارس العلمية في كل مكان، والمؤسسات الثقافية في المساجد وغير المساجد، وانتهت حركة الإبداع عند الأمة الإسلامية.
وبذلك توقفت الحركة العلمية، وانهارت أيضاً الحياة المعيشية لعدم وجود التنمية الزراعية والاقتصادية، ودخل العالم الإسلامي في فقر وتأخر واضح جداً.
مختصر القول، أن هذا الشخير الذي كان يصعد عند المسلمين في حالة نومهم و جمودهم وتمزق ملتهم والتحديات التي أطاحت بكياناتهم وصلت أخباره إلى الغرب، والغرب بمقابل هذا تقدم تقدماً هائلاً في منجزاته الحضارية. وبدأ النفوذ الغربي يدخل العالم الإسلامي مع أواخر القرن التاسع عشر بأشكال متعددة، مثل: المبشرين ومؤسساتهم، والذين انتشروا في العالم الإسلامي. والمستشرقون الذين جاؤوا فدرسوا الإسلام، وأظهروا الإسلام ديناً متأخراً ودعوا المسلمين إلى الالتحاق بالحضارة الغربية عبر كتبهم ومؤسساتهم وجامعاتهم. وتأسيسهم للجامعات لنشر مبادئهم المادية وتقدمهم العلماني الحضاري مثل الجامعة الأمريكية في بيروت والقاهرة، وكلية بغداد، وكلية الملكة فيكتوريا في اسطنبول.
وهكذا استطاعت هذه المؤسسات الثقافية والجامعات أن تجلب العقول الإسلامية والطلاب من كل أنحاء العالم الإسلامي، وربتهم تربية علمانية مادية فيها كثير من الطعن في الإسلام وتأريخ الإسلام والقرآن الكريم والحديث النبوي وحتى التشريع الإسلامي العظيم الذي كتبوا عنه أن هذا تشريع ضعيف مقتبس من التشريع الروماني.
هذه التحديات فيما بعد أدت إلى انتقال المستعمرين -كما قلنا- إلى البلاد الإسلامية واستغلال فرصة (قبل قيام المارد) -والذي يقصدون به الإسلام- وتنفيذ مشاريعهم.
ولكن، لكل تحد لابد من استجابة، والاستجابة إذا كانت أقوى من التحدي قضت عليه، وإذا كانت بمستوى التحدي تستطيع أن تأخر عمله وتدفعه إلى الوراء.
وبما أن الإسلام في كل عهده المتأخر كان موجوداً على الرغم من ضعفه في نفوس المسلمين، كانت هذه التحديات عامل استفزاز ليقظة الشعور وانتباه عقول مسلمة وواعية وحريصة بدأ التفكير والعمل على القيام بمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
هذه الاستجابات تقريباً قامت في وقت واحد، من نهاية القرن التاسع عشر إلى بداية القرن العشرين، وما زالت تلك الاستجابات موجودة في عراك مستمر إلى اليوم مع التحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي. هذه الصحوة والقيام من أندونيسيا إلى المغرب، ظهر فيها مصلحون ينبهون المسلمين إلى حياتهم وتأخرهم والانفصام بينهم وبين قرآنهم، والانفصال بينهم وبين هويتهم وأمجادهم.
ففي الهند ظهر الفيلسوف والشاعر الكبير محمد إقبال، الذي درس في الغرب، وقبل ذلك درس في الكليات الإنجليزية في لاهور، وأخذ الشهادة بعد ذلك من ألمانيا، واطلع على الحضارة الغربية، ودرس أسباب ضعف المسلمين. وكتب كتابه تجديد الفكر الديني، وفي أشعاره المؤثرة عاطفياً وضع أفكاره. هذه الأشعار والكتابات والمقالات في جهود محمد إقبال كانت بداية عظيمة لاستيقاظ المسلمين في الهند، وبداية تأسيسهم للجامعات، والمؤسسات الثقافة، وجمعيات المجتمع المدني. فعبر عقدين أو ثلاثة من الزمان استطاع إقبال وتلامذته مثل وحيد الدين خان وأبو الحسن الندوي وكذلك الأستاذ المودوي -رحمهم الله جميعاً- أن يُحدثوا هذه النهضة الإسلامية التي نراها في الهند.
ونأتي إلى أفغانستان، ظهر جمال الدين الأفغاني،وقد كتبت عنه كتاباً بعنوان: جمال الدين الأفغاني، المصلح المفترى عليه -كان رجلاً ذكياً عبقرياً، درس الإسلام والقرآن والسنة النبوية وتاريخ المسلمين، وعرف من أين أكلت أكتاف المسلمين. عمل أولاً في أفغانستان ثم بعد ذلك ذهب إلى الهند ليحرض المسلمين الهنود على المستعمرين البريطانيين، و كان صراحة يقول: أيها الهنود، لو كنتم مائتي مليون ضفدعة وسبحتم إلى بريطانيا وأكلتم من أطراف جزيرتها لأغرقتموها، فكيف الآن تسلّمون أنفسكم إلى هذا الاستعمار البغيض؟
وأول بدايات مواجهة القرآن الكريم للعالم تمت على يد هؤلاء الرجال، لأن المواجهة لم تكن بين عشية وضحاها وسنة وعشر وعشرين.
هذه المواجهة بدأت عندما قرأ المصلحون القرآن الكريم وعرفوا أنه دستور عظيم وأنه نظام الكون وأنه فيه تجليات الأسماء الحسنى، هذا القرآن الذي أيقظ الأمة الإسلامية وجعلها أمة واحدة، هو الذي يستطيع أن يمد المسلمين وأن ينقذهم، لا العلوم القديمة التي أكل عليها الدهر وشرب.
فالقرآن أُهمل، وهذا القرآن يجب أن يتقدم ويُقدّم إلى العالم الإسلامي من جديد من دون التفاسير القديمة. وأن القرآن الكريم كما كتب عنه الأفغاني في العروة الوثقى يستطيع أن يبني حضارة جديدة للمسلمين وأن ينقذهم من مخلفات الجوانب السلبية في الحضارة الغربية.
حركة جمال الدين الأفغاني انتقلت إلى اسطنبول وإلى مصر، وبقي في مصر حوالي عشر سنوات، وأثّرت هذه الحركة إلى بدايات ظهور الحركة الإسلامية في مصر، وأثّر في تفسير القرآن الكريم في عقل الشيخ محمد عبده، وهو أول من فصّل في المنهج المعاصر في تفسير القرآن الكريم فيما كتب في العروة الوثقى، والذي أكمل مسيرته تلميذه الشيخ محمد عبده، فبدأ يفسّرُ القرآن الكريم في الأزهر، ثم بدأ يكتبه تلميذه السيد محمد رشيد رضا، وكان هذا التفسير (تفسير المنار) تفسيراً عظيماً أدخل الهداية الإسلامية في قلوب الناس.
حركة جمال الدين ومحمد عبده والسيد رشيد رضا أثرت في الجانب الغربي من العالم الإسلامي، وأنتجت مصلحين ومجددين في المغرب، كالثعالبي، أبو شعيب الدوكالي، والمختار السوسي وآخرون، كتبوا في الإصلاح الإسلامي، وكانت جهودهم هي التي أدت إلى الثورة المغربية على الاستعمار الفرنسي وطرده من البلاد واستقلال المغرب.
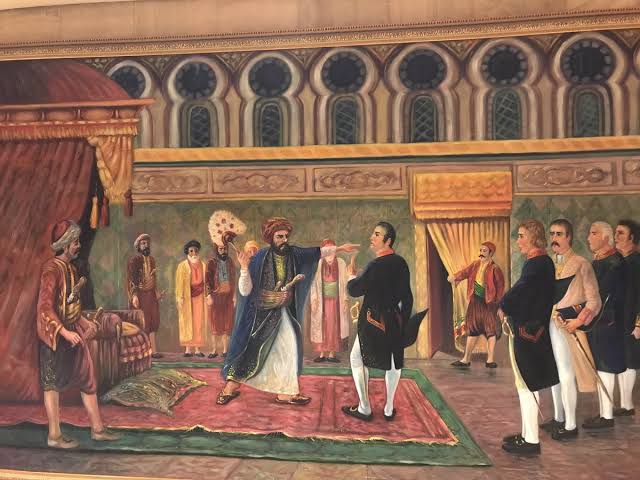
وكذلك في الجزائر التي احتلها الفرنسيون منذ سنة 1830 م، والجزائريون قاموا بحركات وجاهدوا، ولكنهم كانوا متأخرين حضارياً، وفرنسا كانت متقدمة في العلم والسلاح والتقنيات، فاستطاعت أن تسيطر على الجزائر ردحاً طويلاً من الزمان. ثم بعد ذلك ظهر المجدد القرآني الإمام عبد الحميد بن باديس، والذي لم يعلن الحرب، إذ عرف أن الجهاد القتالي ضد الاستعمار الفرنسي صعب جداً لأن الشعب الجزائري نتيجة للمواقف الوحشية للاستعمار الفرنسي عبر 100 سنة أنهت القوة في الشعب الجزائري. ولذلك قال ابن باديس أنه لن يفيدنا هذا القتال المباشر، لا بد لنا أن نهيئ الشعب الجزائري ونربّيه بالقرآن الكريم، لأن القرآن وحده هو الذي يستطيع أن ينقذه، فجلس في قسنطينة في مسجده وبدأ يفسر القرآن الكريم حوالي 25 سنة.
وانتبه الشعب الجزائري بعدها، ومن ثم بنى على أثر هذه النهضة المدارس الابتدائية، والثانوية، مع مقاومة الفرنسيين كانت هذه المدارس تؤدي دورها مع المؤسسات الثقافية والفرق الرياضية والأندية. فعبر هذه القنوات المهمة جداً استطاع عبد الحميد بن باديس بتفسير القرآن الكريم وإيجاد الوعي بين الشعب الجزائري وإعادة حس الانتماء للإسلام لديه، هذه الجهود أدت بعد وفاته بحوالي عشر سنوات إلى تهيئة الجهاد الكامل من قبل الجيش الوطني الجزائري وبعد تقديم مليون ونصف من الشهداء و حصلوا أخيراً على الاستقلال واضطر الفرنسيون للخروج.
وكذلك في تونس ظهور المجدد العظيم الطاهر بن عاشور، فبتفسيره القرآن على منهج الأفغاني الجديد استطاع أن يوقظ التونسيين، والذين استطاعوا أن يقارعوا الاستعمار الفرنسي وحصلوا على استقلالهم فيما بعد، واستطاع بعد ذلك عبر دروسه ومحاضراته إدخال القرآن الكريم في مواجهة العالم المعاصر.
ثم نأتي إلى ليبيا، و دور السنوسيين الذين بذلوا جهوداً كبيرة، فالسنوسي كان في الجزائر وجاء إلى جنوب ليبيا وأنشأ مدينة في الصحراء وطبق فيها كل معاني القرآن الكريم، وهؤلاء الذين تخرجوا من هذه المدرسة هم الذين أشعلوا الثورة الليبية وجاؤوا إلى الحكم.
وفي تركيا، وفي نهاية الدولة العثمانية سيطرت جماعة الاتحاد والترقي المتطرفة الماسونية في العمق، والتي لم يكن الشعب التركي يعرف حقيقتها بداية، إلا وقت خَلعِ السلطان عبد الحميد الثاني. ومن ثم أعلان أتاتورك العلمانية، وتطبيق شروط كيرزون الأربعة وهي: ترك التشريع الإسلامي والمجيء بتشريع سويسري وفرنسي، وإخراج الخليفة وأنصار الخلافة والإسلام من البلاد، وإلغاء الخلافة، وتعطيل الأوقاف والمدارس الدينية.
هذا الوضع أنتج مجدداً عظيماً وعلامة كبيراً ومصلحاً جليل القدر هو الإمام سعيد النورسي (رحمه الله). هذا الرجل عرف أن إعلان الجهاد ضد جماعة أتاتورك لا يفيد، لأن الشعب التركي كحال باقي المسلمين كان متأخراً وجاهلاً بحقائق الإسلام، بالإضافة إلى وجود التحديات التي ذكرتها. فتفرغ إلى التربية وبدأ يكتب رسائل النور تحت مظلة إنقاذ الإيمان، كانت كلها رسائل قرآنية كتبها في ظل تجليات الأسماء الحسنى، وكل ما يؤدي إلى تقديم حقائق القرآن وحقائق الشريعة وحقائق السلوك الإسلامي في هذه الرسائل، و كل هذه الجهود أدت إلى تكوين طلبة النور، واستطاع هذا الجهد أن ينتشر في جميع أنحاء تركيا.
وهنا لا أنسى أن أذكر العمل العظيم العقائدي الذي قدمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب قبل هؤلاء جميعاً في الجزيرة العربية التي استسلمت في بيئاته إلى الشرك والانحرافات وعبادة الجن والسحر وخلو المساجد من أهلها، فسخّر رب العالمين هذا الرجل الذي خدم العقيدة في الجزيرة العربية التي كانت تعيش في الظلام قبل 250 سنة، والذي دَرَسَ تراث ابن تيمية وابن القيم وآخرين من علماء الحديث، وكتب رسائل في التوحيد ودفع الشبهات وفي القضاء على الشرك الذي كان منتشراً حينها، والتفصيل في جهوده وحركته يتطلب محاضرة كاملة.
وأما في مصر وظهور الإمام حسن البنا (رحمه الله) فهذا سيكون موضوعنا القادم بإذن الله.