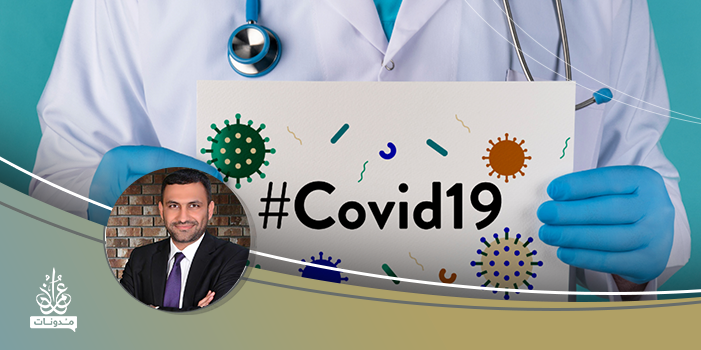ضمن ثقافة أجيالنا المتعاقبة، وفي بنية الوعي الباطن لهذه الأجيال والمجتمعات على تنوعها، تنبع هيبة لامعة عصية على الهدم! وقدسية متمنعة من التدنيس! ولباس إجلال وإكبار واحترام، كلها تغشى شخصية "الطبيب" في مجتمعاتنا.
العاميُّ من أبناء المجتمع وحتى المثقف في الغالب شبيه بالميت بين يدي مغسله عندما يكون في حضرة الطبيب المختص! مُسَلِّمٌ لرأيه ومشورته تسليمًا منقطع النظير، لا نجد شبيهًا لذلك التسليم والاستسلام في زوايا حياتية أخرى، وكلمة الطبيب هي الفيصل دائمًا في حسم مصداقية معلوماتنا الطبية وصحتها، وكلمته فيصل أيضًا في محطة التنازل عن أوهامنا التي قد نجنيها في عقولنا من ثقافة البيئة وحصاد السنين الذي نعايشه؛ لأننا باختصار نعتقد ونجزم -وهي الحقيقة أيضًا- أن وصف "الطبيب" مستأثرٌ بألمع عقول أبناء المجتمع وأنجبها، وأكثرها نباهةً ودقة في التفكير والنظر، ولا يمكن تعدي هذه العتبة والوصول إلى هذا الوصف إلا بصحبة العقول الفذة والحادة في الذكاء، حتى إنَّ ثقافة أطفالنا منذ زمن قديم تحتضن هذه الهيبة والإعجاب! وحين يُسأَل الطفلُ: ماذا تريد أن تكون؟ يُجيب في العادة: سأكون طبيبًا! وعندما يلحظ المجتمع نبوغًا ولمعانًا علميًا من أحد أبنائه، لا تتشكل صورة في أذهان المجتمع لذلك العقل إلا أنه طبيبٌ في مستقبله.
"كورونا" برياحها العاتية وآثارها المتراكمة وأذرعها المتمددة شكلت نمطًا آخر في عقول المجتمعات! صورةً تختلف عن سابقها! في التعاطي مع إرشادات الطبيب ونصائحه، فلم يعد ذلك التسليم المطلق لقداسة الطبيب! ولا تلك الهيبة لمشورته! بل من السهل جِدًّا أن يُشوِّش على رأي ألمع المختصين ومشورته! ويُزعزع قيمةَ إجماعهم ومصداقية نتاج مختبراتهم وجامعاتهم وتخصصاتهم لاعبُ كرة مشهور! أو فنان تلفزيوني! أو حتى "مودل" أُميٌّ في ميزان المعرفة! بل سفيه من سفهاء الشوارع! لكنه يجتاح بصوته وصورته وسُخفه مواقع التواصل التي تصل إلى كل فرد من أبناء المجتمع!
نسمع جميعًا كل يوم وفي كلِّ فضاء إعلامي صراخ المختصين، ألمع أساتذة الدنيا! وأفخم مواطن المعرفة وأكثرها رصانة في عالم اليوم، تنادي بكل ما أوتيت من وعي ومهارة وقدرة على الإقناع، وتتكئ على تلك القدسية والهيبة التي تشكلت في وعي الجمهور عبر الزمن: يا أيها الناس من الضروري أن تتحصنوا باللقاح ضد وباء كورونا! من الضروري أن تتلقوا اللقاح لحمايتكم وحماية مجتمعكم! والجواب سريعًا من جمهور عريض: حَدَّثنا البقّالُ والبَيطَرِيُّ والعَشّابُ وسائقُ الباص! إياكم من التورط بنقمة اللقاح! فثمة خبايا وحكايا ومؤامرات تحاك لمجتمعات الأرض من خلاله فاحذروه! ثم ينجح في كثير من الأحيان خبر "حدثنا الأُميُّ أو غير المختص" على "رسالة الحاذق المختص المتفاني في النصح"! هل تلاحظون هذا الانقلاب في الوعي تجاه الطب والطبيب؟!
وهذا الحال لا ينطبق على مجتمعاتنا العربية و"الشرقية" كما يحلو للبعض تسميتها فحسب! بل هو فيحٌ تستنشق ضرره كل المجتمعات! شرقيها وغربيها! وإن كان الأمر يختلف في القَدر والكَمِّ من مجتمع إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى!
والسؤال هنا! من الذي يُشكِّلُ وعينا في هذا العصر؟! ومن الذي يوجه ثقافتنا ومعرفتنا وعلومنا؟! وبالتالي من الذي يستأثر بتسيير سلوكنا وقرارنا؟!ومن الذي يتولى إدارة بوصلة حياتنا؟! أو على أقل تقدير من يؤثر تأثيرًا بالغًا في كُلِّ هذا؟!
كانت المعرفة التخصصية المنظمة شحيحة في زمن مضى! يعجز عن تحصيلها أو فحصها العوام تمامًا إلا من مصدر محدود، بل حتى المثقفون! يصعب عليهم تحصيل المعلومة الموثوقة في مختلف التخصصات من مصادرها الأصلية! متخصصًا! أو كتابًا! أو دراسة وبحثًا علميًّا! لذلك يخضع الجميع لسلطة المُختص المتوفر القريب! فيُسَيِّر ذلك المختص بمشورته ومعرفته الجماهير! خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأرواح الناس وصحتهم، وميدان ذلك الطب والطبيب! المستشفى والمركز الصحي! ومن لبس لباسهم وحظي بثوب قداستهم، في الحي والمدينة والقرية.
تمزقت في عصر اليوم كثيرٌ من الحُجب! لم يعد في رفوف أسماع أبناء المجتمع رأي طبيب الحارة وحده! لم تعد مشورة خبير المدينة أو البلد مستأثرة بعقول المجتمع ووعيه! فثمة انفجار معلوماتي رهيب! يُدَوِّي في أسماع الصغير والكبير في كل لحظة، الشاشة الكبيرة والصغيرة ملأت عقولنا بمعلومات، ليس للمجتمع بمجموعه أهلية في تمييز مصداقية تلك المعلومات واختبارها؛ لذلك طاشت في هذا الفضاء أفهام وعقول وشخصيات! وتسرَّب كثير من مخزون الوعي الراكد في أذهان الجماهير، بغض النظر عن سلامة ذلك الوعي أو عدمها.
الإعلام بمنصاته المختلفة ومنابره المتنوعة يُشكِّل الجزء الأكبر من وعينا! حتى لو كان مزورًا وكَذُوبًا ومُتهمًا عند الكثيرين! لكنه بالنهاية يُشكِّل الوعي الجمعي مع التكرار والمهارة والتلميع والقدرة الفائقة على التوغل في الطرق الملتوية وتسويق المادة المراد ترويجها، وبعدها يحصد المرء من هذا الهدير المُروَّج غنائم متنوعة! ومتناقضة أحيانًا! الصالح منها والرديء، وفي الأخير تشتتٌ واضطراب في الرأي والسلوك لا يمكن انضباطه بحال، ولا خضوعه لرأي حكيم مختص بعينه.
ثم إننا في زمن زادت فيه روح التوحش والجشع والنفعية والأنانية! بأبشع صورها، ولا يمكن إنكار هذا! وهو ظاهر مُتعرٍّ في سياسة الحاكمين والمتحكمين! ومن بيدهم زمام الأمور ويديرون خيوط اللعبة، من ساسة وقادة وتجار وشركات ومؤسسات!
مقابل هذا القُبح المكشوف من الطبيعي جدًا أن ترتفع وتيرة الخوف والحذر والشك وسوء الظن؛ تجنبًا لتداعيات تلك الأمراض الإنسانية الخطيرة التي تجتاح المجتمعات وتقف على هرم أولوياتها، فالإنسان أيًّا كان موقعه، وعلى أي شكل ومستوى كانت ثقافته ورتبته، يُجلُّ نفسه من أن يكون يومًا ضحيةً لهذا النوع من التوحش والجشع الإنساني.
إثر هذه القناعات المتراكمة، المبنية على نماذج من الأحداث والتجارب والوقائع تشكلت قناعة الرفض اللاواعي لدى جمهور كبير! الرفض لكل ما ينبع من ميدان نشكك فيه ونتوجس ونحذر منه! لا لشيء إلا لأنَّنا نتوقع أنَّ سوءً ما خلف الأكمة، ربما لا نعرفه ولا نستطيع اكتشافه، لكنَّ الرفض المطلق هو الطريق الأقرب للتخلص من شره والسلامة من أثره.
ونحن هنا لا ننكر طمع الشركات وجشع المنتجين ونفعية التجار في كل ما يُقَدّم للبشرية، لكننا في نفس الوقت لا نستطيع إنكار جليل ما تقدمه تلك المؤسسات والشركات من خدمات للإنسانية، على مستوى الطب خصوصًا، ونحن نتعامل معه كل يوم في بيوتنا ومستشفياتنا بكل مرونة! فلماذا كان ذاك مرعبًا وهذا سهلًا مستساغًا؟
السياسة المفترسة والفاسدة في نظر المجتمعات وفي كل بلاد الأرض مع كونها الحاكمة على مسيرة الحياة بتفاصيلها جعلت كل فرد يشعر بريبة تجاه ما تنتجه المؤسسات المحكومة بهذا السياق! ولو كانت تدعي الحيادية والعلمية والتخصصية! فشبح السياسة وزورها وشرها يختبئ خلف كل ستار! ويستوطن جعبة كل مفصل من مفاصل الحياة، فلا عجب أن تختار الشعوب والمجتمعات الهروب من هذه التبعية والخضوع، والهلع من كل ما تُروِّج له تلك الحكومات المنخورة بالشرور.
نعم... من الطبيعي أن تسمع رسائل التوجيه وبيان المحاذير وإمكانية عدم السلامة المطلقة والمخاوف تجاه بعض الأعراض غير المكتشفة للقاح طارئ ومُعجَّل تختلف مسيرة تجريبه واختباراته عن غيره من لقاحات سابقة! لكن ليس من الطبيعي أن تسمع تلك الغوغائية في التنفير والعبثية في التفكر وإثارة الهلع في نفوس المجتمعات تجاه ذلك المنجز الذي يخدم المجتمعات والبشرية من وجوه كثيرة.
وهنا بكل تأكيد لا نريد طمس حاسة الحذر والتأهب التي تحمينا من البلادة والطمس والذوبان، لكننا في نفس الوقت نطمع بترشيد حاسة الخوف التي تحرمنا من دائرة الوعي والإدراك ورؤية الأشياء على حقيقتها بصورة متوازنة.