وصف فرانسيس بيكون في كتابه "البحث الجديد.. أورغانون نوفا Organon Nova" أوهام العقل فاختصرها في أربعة: أوهام القبيلة وخيالات الكهف وخداع السوق وألاعيب المسرح، فأما أوهام القبيلة فهي مشكلة عقل الإنسان، أنه مرآة مقعرة، على نحو ما، بمعنى أنه يرى الأشياء في ضوء الهوى والتقاليد التي نشأ فيها، أما أوهام الكهف فهي شخصية، كما وصفها (أفلاطون)، أن أحدنا يسكن في كهف من التصورات، وأن النور الذي يأتي من الخارج يترك ظلاله على جدران الكهف؛ فلا نرى الحقيقة إلا بعمل عقلي مجرد، وهيهات أن نصل الى الحقيقة، وتحت ضغط هذه الفكرة وصل الفيلسوف بيركلي إلى اعتبار أن العالم وهم؛ لأن ما نراه لا يمثل العالم، بقدر الكاميرا العقلية التي نحملها داخل رؤوسنا.
أما أوهام السوق فهي التي تنشأ من عالم المال والأعمال، واجتماع الناس وتأثر بعضهم ببعض، ومن هنا اعتبر القرآن أن أكثر الناس لا يعقلون، لأن الميديا تلعب دورها في إنشاء هذيان الجماهير، وانهيار الأسواق المالية لا يتبع قواعد موضوعية، بقدر جموح العواطف، وتخوفات البشر، وأوهامهم حول الأشياء، ومنها كارثة الرهن العقاري الأمريكي عام 2008م التي قادت إلى زلزلة العالم، والواقع أن الديمقراطية جيدة، عندما يوجد الوعي، وإلا أصبحت مهزلة؟! ورصيد الديمقراطية يبقى وعي الأمة قبل الصناديق.
وأما أوهام المسرح فهي التي انتقلت إلينا من الفلاسفة والمفكرين، أي تلك الأفكار التي نتلقاها دون تمحيص، ولذلك فإن بيكون اقترح علينا، أن نتحلى بالعقل النقدي أكثر من النقلي، كي نؤسس لمعرفة سليمة، والقرآن نهى جدا على اتباع الآباء فقال: (أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ)، يخلص بيكون إلى هذا الاستنتاج الثوري: (يجب أن نقذف بجميع نظريات القرون الوسطى بعيداً، كذلك الجدل والحوار والنظريات، التي تحتاج إلى إقامة البرهان وننساها. ويجب على الفلسفة كي تجدد نفسها، أن تبدأ مرة ثانية بقلم جديد ولوح نظيف وعقل مغسول مطهر، لذلك تكون الخطوة الأولى في الفلسفة هي تطهير العقل وتنقيته، وكأننا عدنا أطفالاً صغارا أبرياء من الأفكار والأحكام المسبقة، إن مشكلة المنطق الأولى هي تتبع مصادر هذه الأخطاء وسدها).
هذه الأقوال هي لفيلسوف بريطاني عاش 65 سنة، بين 1561 و 1626 م، ولكن بصماته مازال لها الأثر في الفكر الإنساني حتى اليوم، هو (فرانسيس بيكون)، ويجب أن نفرق هذا عن جبل آخر من العلم هو (روجر بيكون) استفتح عصر التنوير سميه فرانسيس بقرون.
الفيسلوف البريطاني فرانسيس بيكون (1561-1626)
ويعلق المؤرخ الأمريكي (ديورانت) على أثره في الفكر، أنه شق طريقاً جديداً في الفلسفة، بعد أرسطو، تعتمد الجانب العملي التجريبي، وتشبه قصة هذا الفيلسوف البريطاني، حياة ابن خلدون فقد جمع بين الفلسفة والسياسة، وهي خلطة صعبة إلا على من يسرها الله عليه. وارتقى في المناصب الحكومية، حتى أصبح رئيس وزراء، في عهد جيمس الأول، ولكن السياسة حصان جموح غير قابل للترويض؛ فقد جلبت لنفسه المتاعب والحساد؛ فكادوا له كيدا ورموه في غياهب السجن. وفي نهاية حياته ذاق مرارة الفقر بعد نعمة الغنى، ولكنه عكف على إنتاج أفضل شيء للبشر، أي الخلاصات الفكرية في عدة كتب. وبقي بيكون نشيطاً حتى أيامه الأخيرة، وعندما كان في طريقه لزيارة أحدهم خطرت له فكرة عن حفظ الدجاج أو اللحم عموما؛ فكم من الوقت يحتفظ الثلج بلحم الدجاج دون فساد؟ وعندما سارع إلى تطبيق التجربة على نفسه؛ انتابته عرواء ومرض ومات، غالبا من التهاب رئوي حاد، في وقت لم تكن الصادات الحيوية موجودة، ولم يكن يعمر إلا القليلون النادرون.
هكذا مات سبينوزا عن عمر 42 سنة بالتهاب صدر، وجن نيتشه بالتهاب الدماغ الصمغي في عمر 50، وقضى صلاح الدين وهو كهل بالتهاب الطريق الصفراوي، وأما الإمام الشافعي فمات من البواسير، وهي اليوم تحل بعملية بسيطة، وأوصى بيكون أن يكتب على قبره: (أترك روحي إلى الله، وأما جسدي فأمره إلى المجهول، وأما اسمي فأبقيه للأجيال القادمة والإنسانية جميعاً.)
مما عرضنا عن الفلسفة وروادها فهي تعتبر في نظر البعض مصدر إزعاج، كما أنها مصدر تهديد للعقيدة عند آخرين؟ والبعض يصاب بالدوار مع تعاطي عقار الفلسفة؛ فهي تسحب من تحت أقدامه المسلمات واليقينيات، ولكنها بالمقابل عند آخرين مصدر متعة بدون حدود، لأنها تأخذه إلى عوالم سحرية، لا تكف عن التجدد وتغيير شكلها الخارجي دوما، مثل عروس تبدل أناقتها باستمرار.
ومن نهض بالعقل في التاريخ هم بضع مئات من أدمغة الفلاسفة، وحسب برتراند راسل الفيلسوف البريطاني في كتابه (النظرة العلمية) فإن عصر النهضة كله يدين إلى مائة دماغ، ولو تم اغتيالهم أو القضاء عليهم أو ماتوا، لما كان هناك نهضة وناهضون!
مع هذا فالفلسفة رحم العلوم، وهي تشبه من جهة شجرة باسقة تضرب في الأرض بجذورها، جذعها العلوم، وثمارها التكنولوجيا والصناعات. وهنا نرى جدلا بين ثلاث؛ الفكر والعلم والأشياء. فلا يتقدم العلم بدون أرضية راسخة من حرية الفكر الفلسفية، لأن الفلسفة فتح للعقل على كل أنواع الأسئلة المزعجة والمحرجة بدون حدود وخوف.
ولم يكن للحضارة الإسلامية أن تنهض لولا اتصالها بالفكر اليوناني، كما قررّ ذلك عبد الرحمن البدوي في سيرته الذاتية، وهو كتاب جدير بالتأمل، يشبه من جهة كتاب خارج الزمن لإدوارد سعيد، أو حفريات في الذاكرة للجابري المغربي، أو قصة الإيمان لنديم الجسر، والكتب القيمة نادرة، ومن ينتبه لها أندر من النادر.
ولن ننهض اليوم إذا لم نتصل بالفكر الفلسفي العالمي، وهي مسافة خمسة قرون، والفكر الفلسفي يجب أخذه مفصولا عن التاريخ الاستعماري وفتوحات بوش التعيس؛ فالفلاسفة والمفكرون قوم لا وطن لهم وهم إنسانيون، ربهم واحد، مثل الأنبياء أولاد علات أمهاتهم شتى. أما نحن فمثلنا مثل من كان جده ملياردير وهو مفلس، فما يزال يتحدث عن ثروة جده العظيمة، التي لم يبق منها شروى نقير. وهي حجة لن ننهض بها، فضلا على أنها مخدرة لنا عن إبصار واقعنا المزري. فهذا تفكير ضار يجب التخلص منه والتخلي عنه، لصالح فكر مفيد يبني، وإلا كان مثلنا مثل الشيطان الذي مضى إلى طريق اللاعودة واللاتوبة، لأنه لم يراجع نفسه، ولم يعترف بالخطأ كما خالفه أبونا وأمنا من قبل آدم وحواء فاعترفا، أما الشيطان فقد نسب الخطأ إلى الرب فقال بما أغويتني.
وربما كان الفيليبينيين في هذا الجانب أفضل من العرب، لعدم وجود تاريخ زاهي عندهم، فهم يعتمدون على سواعدهم لبناء أنفسهم. ويعتبر نيتشه ضوء باهر في الفلسفة، من الذين بحثوا عن الحقيقة بأي كلفة. فاعتبر أن من أراد أن يرتاح فليعتقد، ولكن من أراد أن يكون من حواريي الحقيقة فليسأل؟ أما سقراط فيعتبر فلتة عقلية في التاريخ، وأخطأت أثينا في حقه فحكمته بالإعدام وهي ديمقراطية، وهذا يحكي أن الديمقراطية أحيانا عوراء عرجاء جدعاء كسحاء!
ويرى سقراط أن الفلسفة لا تجيب عن الأسئلة؛ بقدر فتح الباب مع الإجابة على كل سؤال، بسؤالين جديدين، مما يشكل زاوية منفرجة للمعرفة، لا تكف عن الاتساع. ومنه فإن الغربيين يعطون لقب فيلسوف لمن يحصل الدكتوراة في العلوم، ولكن لا ينتبه أحد لهذا اللقب (PhD). ويسمونه دكتور وهو فيلسوف! ومع أن ماركس أعلن (موت الفلسفة) إلا أنها حية جذعة لا تكف عن مد أغصانها في كل حقل معرفي.
الفيلسوف البريطاني برتراند راسل (18 مايو 1872 - 2 فبراير 1970)
ورأى برتراند راسل أن الفرق بين الدين والفلسفة والعلم، أن الفلسفة منطقة لا اسم لها، تتأرجح بين الثيولوجيا والعلم، ومعرضة للهجوم من الجانبين. فالدين يعطي إجابات نهائية قاطعة، عن قضايا غامضة غير قاطعة، لا جواب لها عند العلم، مثل ما بعد الموت، وانشراح النفس، ومعنى الصلاة، وبداية الكون ونهايته، وهدف الحياة، والحياة الروحية، وجدلية الفناء والبعث والنشور. أما العلم فهو يهتم بعمليات الكفن والدفن، وتحلل الجثة، والطب الشرعي، والصمل الجيفي (تخشب الجثة بعد الوفاة بساعات). العلم يبحث في الكيف؟ فكيف تتشكل السحب؟ ومما يتكون بناء الذرة والمكونات دون الذرية من الكواركز واللبتونات؟ والكود الوراثي في نواة الخلية؟ ولماذا يحدث التسونامي من تصدع وصدم صفيحات قشرة الأرض ببعض؟ والعلم يقول أن سبب ملوحة البحر هو كلور الصوديوم، ولكن الفلسفة تقوم بتعليل ذلك، ولا تكف عن التفسير، وتقفز من تفسير لآخر، وتتحرك من تعليل لثاني، فتهب حركة دائمة للعقل، ونمو معرفي بآلية الحذف والإضافة. ويقولون في تعريف الفيلسوف أنه ذلك النهم للمعرفة، ولا يكف عن القراءة ولو في وسط حشد من الناس، غارقا في سحر الكلمات والأرقام، يقرأ قياما وقعودا وعلى جنبه، ولو في حافلة ومترو متعلق ذراعه بقضيب معدني في باص!
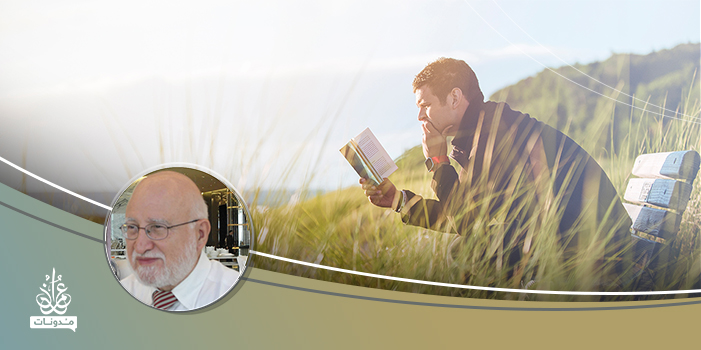
.jpeg)
.jpeg)
